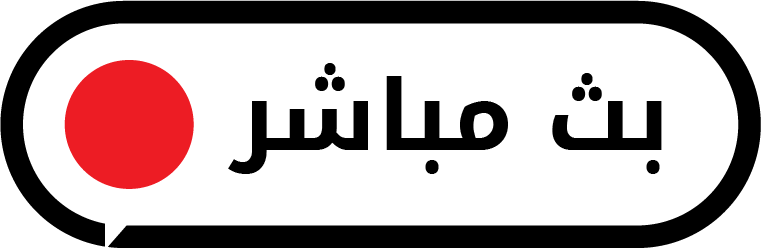أنت هنا
القائمة:
روحانية عيد ارتفاع الصليب
يأتي هذا العيد من خبرة الكنيسة في الأجيال الأولى، التي اختمرت مع تحديات الجماعة فخرجت بروحانيَّة عاشتها الجماعة الاولى وامتدت عبر الاجيال. خبرة هذه الحياة، نَمَتْ وكبُرَتْ، وما زالت الكنيسة والمؤمنون إلى اليوم، يعيشون هذه الرُّوحانيَّة المسيحيَّة النابعة من صلب حياة يسوع المسيح، حبَّة القمح التي ماتت وأزهرت خلاصًا للعالم.
هذا العيد يرفع قلوبنا وأذهاننا إلى العُلى، ليكون سلّم خلاص، طالما سعَتِ البشريّة إلى أن تعبر عليه إلى الله. فالصّليب هو نقطة لقاء بين عالمين، عالم أفقيّ، هو العالم الإنسانيّ والأرضيّ، وآخر عموديّ يصل الأرض بالسماء.
هذا هو صليب المسيح، عارضتان متلاقيتان فيهما معنى الحياة كلها.
ولكن، لا بُدَّ من الإقرار بأنَّ الحياة الأفقيّة لا تتضمّن قفزات نوعيّة في الحياة البشريّة. جلَّ ما تقوم به، هو توصيف الواقع البشريّ ودراسته وتمحيصه، واقتراح بعض حلول بسيطة لا تُخرج الإنسان من دوّامته المحبِطة. ما هي الأجوبة التي يمكن للبعد الأفقيّ أن يعطيها عن الحياة والمرض والموت والصعوبات!!! وأيَّة حلول يمكن للبعد الأفقيّ أن يعطي للتعب والتضحية والعطاء والمحبّة. فكثيرة هي هموم الحياة الأرضيّة، وكثيرة هي التفسيرات التي اعطاها المفكّرون لتسهيل قبول الحياة، والعيش في تعاريجها. ولكن، لا يُمكن للأجوبة البشريّة أن تشفي غليل من يسعى إلى الكمال، خاصّة إذا كان الكمال خارجًا عن الدائرة الأرضيّة.
لذلك لا بُدَّ من الاعتراف أنّ العارضة الأفقيّة وحدها تحمل معها الكثير من المشاكل أكثر ممّا تقدّم حلولاً للحياة البشريّة، وأخطر ما تقدِّمه هذه العارضة، أنّها تختصر الحياة هنا على الأرض، كأنّها أساس لذاتها وغاية في ذاتها. ولا يمكننا أن ننكر أنَّ الكثير من أقراننا وأصدقائنا وأهلنا الذين نعايشهم، يعتقدون أنّهم يحتكرون الحياة، ويتحكّمون بها كما يتحكّمون بسعر السوق أو بإدارة شركاتهم، وأنّهم بخبراتهم، لهم الباع الطويل (وسع المعرفة والعلم) في فهم حيثيّات الحياة ومنطلقاتها وغاياتها. ولكنّنا، للأسف، نقف كلّنا عاجزين أمام أيّة مشكلة صغيرة، أو كلمة بشريّة جارحة، أو إحباط تأتّى ممّا لم نحسب له حسابًا، من دون أن نذكر جوهريّات الوجود، وأخلاقيّات التصرّف، وأزمات المرض والموت، وفقدان عزيز... وكلّها أمور يقف البعد الأفقيّ عندها عاجزًا، لا بل يستسلم أمامها، ويتهيّأ لنا أنّ الحياة انتهت في حين أنّنا ما زلنا نعيشها.
نفتّش عن حلول، وعن آفاق، وعن معنى لهذه الحياة، ويميل قلبنا إلى الاعتقاد أنّ الشباب دائم، وأنّ النجاح دائم، وأنَّ الصحّة لن تغيب، وإن الحياة لا تنتهي...
والأكثر من ذلك أنّنا عند أيّة صعوبة ننظر أفقيًّا، لنلوم الله المتسامي عن عجزه في تركيبة كثيرة الوهن. تغرينا فكرة أنّ الحياة بلغت إلينا، وأنّها لن تسير إلى الأمام، وإذا ما سارت فستنحصر فينا!
وعند أيّة معضلة لا نفهمها نوجِّه إلى الله، وإلى الحياة، وإلى سرِّ الوجود إيلامًا ما بعده إيلام، من دون أن نكون قد توقّفنا يومًا للتأمُّل في مسيرة الحياة ومسارها، وفي الله مصدرها وسبب استمرارها. ونصبح كمن يتكلّم بما لا يدري، ونُنصِّب أنفسنا قضاة على الله وعلى الحياة. وفي أفضل الأحوال ننسب ما لا نفهمه إلى الصُدَفِ وإلى الأقدار!
ولكنَّ هذا العيد يدعونا إلى أن نتأمّل في العارضة العموديّة التي تصل الأرض بالسماء، والتي في صعودها تمرّ بتلك العارضة الأفقيّة، وتشكّل لنا صليب الخلاص وتأخذ معها معضلاتنا، ومشاكلنا، آمالنا وطموحاتنا... لتفتح لها أفقًا متعاليًا وليس مستويًا كما درجنا عليه.
هذا العيد يجمع العارضتين ليتشكّل بلقائهما الصَّليب، صليب ربّنا يسوع المسيح الذي جمع في شخصه السَّماء والأرض، الألوهة والبشريّة، الأفقيّ والعموديّ. وحرّر البشريّة من الموت، وحمل لها حياة جديدة.
نختبر هذا اللقاء مرارًا من دون أن نسلّم بنتائجه، ليس لأنّ يسوع محا الموت، بل لأنّه جعل من موته حياةً للآخرين. "إنَّ حبّة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت، تبقى مفردة".
في هذه المقاربة الجديدة للحياة البشريّة، جعل يسوع من الموت عملاً خلاصيًّا! ففي كلِّ مرَّة نموت عن ذاتنا نحيا في الآخرين. وإذا بالحياة المفردة، التي نتشبّث بها على المستوى الأفقيّ، تتحوّل إلى حياة غنيّة على المستوى العموديّ، فتصبح "حيوات" كثيرة تتجدّد من خلال الوعي بإغناء الحياة الفرديّة بما ننتسب فيه إلى الحياة، فتنسكب حياتنا في حياة الكنيسة، وفي حياة العالم خلاصًا ونورًا، لتكتمل مسيرة طويلة بالصعود بالله.
هذا البعد العموديّ لا يطرح أجوبة "ثابتة" مقفلة لنحبسها في خزنتنا الشخصيّة، بل منهجيّة "ديناميكيّة" تعطي الحياة معناها، ليس بفهم تفاصيلها الجامدة، إنّما بفضل انسكابها في نهر الحياة، الآتي من الله، والعائد إلى الله. فالمرض مثلاً يصبح دخولاً في فهم هشاشة الحاضر الذي يؤهّلنا للمستقبل. والألم يصبح بلوغًا (كبلوغ الثمر) فيحين قطافه لأنّه بلغ ملئه، وصار الوقت لنتغذّى به. والموت اكتمال لهذه المسيرة التي، في مطلق الأحوال، لا نمتلكها، ولكنّه يجمعنا بكمال الألوهة.
في الصّليب تنقلب المقاييس، ومن لقاء العارضتين تخرج ديناميّة تبثّ الحياة في الوجود، ليس لأنّه يقترح فكرًا جديدًا، بل لأنّ يسوع بتبنّيه طبيعتنا وموته عليه، قدَّم ذاته وجدَّد طبعنا، إذ اجتمع فيه وعليه البعد الأفقيّ والبعد العموديّ.
أدعوكم إخوتي، في هذا العيد عيد تجلّي الصّليب، أن نتأمّل في هذين البُعدين، الأفقيّ والعموديّ، ولا نكتفينّ بذاتنا، وبأفقيّتنا لأنّنا بذلك سنخسر المعنى، وسنخسر بالتالي ما نعيشه، وما نتقاسمه مع الآخرين.
"فيسوع ذاته يقرّ: أنّه أتى لمثل هذه الساعة"، وكلّما استوقفتنا الحياة، نشعر أنّنا على مثاله اختُرنا لمثل هذه الساعة، ساعة التجلّي، ساعة ارتفاع الصّليب، أو ساعة ارتفاع الخبرة البشريّة الأفقيّة إلى بعدها الأزليّ العموديّ فيتشكّل بذلك صليب المسيح طريقًا للخلاص ونهجًا للقيامة.
لا بُدَّ من الاعتراف بأنّ الصّليب ليس مرسومًا فقط على جباهنا أو على صدورنا، إنّما هو الهيكل السريُّ والأساس الحامل الذي عليه نبني إنساننا والبشريّة جمعاء. وما بُنيَ على أساس ثابت يقول المسيح، لا تزعزعه العواصف، ولا الريّاح، ولا مياه الغمر الكثيرة، بل يدوم، لأنَّ أساسه في الله.
سلام المسيح فليكن معكم.
بقلم المطران د. يوسف متى