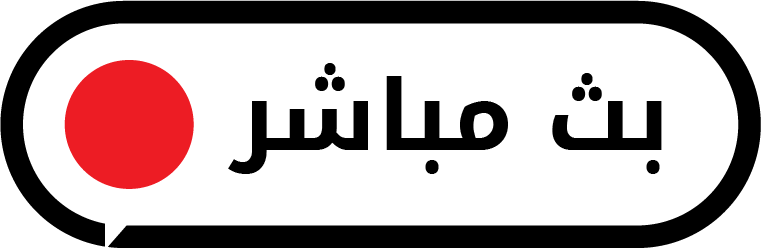أنت هنا
القائمة:
الأحد 5 تموز 2020
الأحد الخامس بعد "العنصرة" – أحد "شفاء مجنونَي الجدريّين"
نقرأ فيه الإنجيل بحسب متى (متى 8: 28 إلى 9: 1)، وفيه يُحرّر الربّ يسوع إنسانَين مُعترَين من "شياطين" كثيرة، مُظهِراً بذلك سلطانه على "الأرواح النجسة".
مُلخّص عبرة إنجيل اليوم:
* آيات يسوع هي علامات تُشير إلى الهويّة الإلهيّة لصاحبها، وإلى حلول ملكوت الله.
* في آية اليوم، يُظهر يسوع سلطانه الإلهيّ المُطلَق على "الأرواح النجسة" .
* "الشياطين" تعرف يسوع، وتعرف أنه جاء يرفع قبضتها عن كاهل البشريّة .
* إن الغاية النهائيّة من كرازة يسوع هي تحرير الإنسان من موبِقاته "الترابيّة"، وتعبيد الطريق أمامه للحياة الحقّة بالله.
************************************************
أولاً – مُقدّمة لإنجيل اليوم:
في الأحد الفائت، رأينا مع متى الإنجيليّ إحدى علامات حلول "ملكوت السماوات" (أو حضور الله بين البشر)، علامة تجلّت في "إبراء غلام قائد المئة"، بناءً على الإيمان العظيم الذي أظهره قائد المئة بشخص الربّ يسوع. وكان ذلك درساً لنا في الإيمان، سواء من ناحية أهميّته الحيويّة في علاقتنا مع الله، أو من ناحية الحذر من الوقوع بالإعتزاز "الفارغ" بإنتمائنا المسيحيّ (كما فعل "أبناء الموعد")، أي الحذر من مقولة "نحن مسيحيّون، وهذا يكفينا"...
اليوم، نُتابع مع متى مسيرة التعرّف إلى شخص الربّ يسوع من خلال علامة جديدة للملكوت، آية يكون تلاميذه شهوداً عليها أيضاً، ويُظهِر فيها سلطانه المُطلَق على "الأرواح النجسة". الجدير ذكره أن رواية آية اليوم تقع مباشرةً بعد رواية آية "تهدئة العاصفة" (حيث أظهر يسوع سلطانه على قوى الطبيعة)، وقبل رواية آية "شفاء مُخلّع كفرناحوم" (سلطان يسوع على غفران الخطايا)... لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن موضوع "الأرواح النجسة" كان موضوعاً حسّاساً في تلك الحقبة والبيئة، وكثيراً ما كانت تُنسَب أمراض وظواهر غريبة إليها، ولا يكون الشفاء منها إلا من قبل الله.
اليوم إذاً آية جديدة، أو علامة جديدة على تحقيق وعد الله للبشريّة وحلول "ملكوت السماوات". في فصل إنجيليّ آخر، يُجيب يسوع على سؤال المعمدان من خلال مُرسَليه قائلاً: "العمي يُبصِرون والعرج يمشون والبرص يَطهرون والصمّ يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشّرون"، دلالةً على إشارات حلول الملكوت ومجيء "الماسيّا" المنتظَر.
------------------------------------------------
ثانياً – قراءة تأمليّة لإنجيل اليوم:
اليوم، يخرج الربّ يسوع من النطاقَين الجغرافيّ والبشريّ المُعتادَين، حيث كان يكرز بملكوت الله في الجليل وسط "الخراف الضالّة من آل إسرائيل"، ويتوجّه إلى منطقة مُقابِلة، أطلق عليها متى إسم بقعة "الجدريّين" (أو "كورة الجرجسيّين"). ويبدو أن هذه البقعة يكثر فيها "غير اليهود"، بدليل وجود قطعان للخنازير في كنفها. لا بدّ من الإشارة هنا، إلى أن الإنجيليّين "الإزائيّين" الثلاثة قد أوردوا الرواية نفسها، لكن متى تكلّم عن مجنونَين (متى 8: 28-34)، فيما تكلّم مرقس ولوقا عن مجنون واحد (مر 5: 1-20) و(لو 8: 27-39). كما كان متى أكثر دقةً في تسمية ووصف مكان حصول الآية (بقعة "الجرجسيّين")، فهو يعرف المنطقة وشعبها أكثر من مرقس ولوقا، وهو أساساً شاهد عيان للربّ يسوع (كونه من "الإثني عشر")، ويُخاطب جمهوراً من المؤمنين من أصول يهوديّة. بينما مرقس ولوقا يُخاطبان مؤمنين من أصول "أمميّة" (وثنيّة). مهما يكن الأمر، فإن جوهر الخطاب واحد، وهو إظهار سلطان يسوع المُطلق على "الأرواح النجسة"، ومسيحانيّته من خلال كل أعماله.
تستوقفنا في رواية اليوم أربع نقاط أساسيّة:
* في النقطة الأولى، إن المكان الذي أتى يسوع إليه اليوم، هي أرض غريبة نسبيّاً عن البيئة التي إعتاد يسوع أن يُبشرّ فيها. وهي ترمز إلى أرض "الغربة عن الله"، حيث مرتع "الشياطين" وحيث تكثر الخطيئة والموت، وذلك يتجلّى بصورتَين: الخنازير والقبور. وليس أدلّ على ذلك من المُقارنة مع "الأرض البعيدة" التي إنطلق إليها "الإبن الضال"، والذي وصل إلى الحضيض لدرجة أنه إضطرّ لأن يرعى الخنازير ليبقى حيّاً (جسديّاً)، وهو "حيّ – ميت " فعليّاً... إلى ذلك، نُضيف نقطة مهمّة جداً، وهو أن "ساكني" هذه البقعة يكونون على صورتها، والعكس بالعكس. فمن يغيب الله عن حياته، يدخل فعليّاً "قبر النفس" وتُعشّش "شياطين النفس" في حياته وتصرّفاته كلّها...
* في النقطة الثانية، يستقبله إنسانان مجنونان، ممسوسان، مُعترَيان (التوصيفات كثيرة)... وفي مفاهيم ذلك الزمان، كان يُقال إن "فيهما شياطين كثيرة". وكان هذان يسكنان القبور (رمزاً لإنفصالهما عن المُجتمع)، وكانا هائجَين جداً (دليل إنفصالهما عن الواقع)... ليس لهما من "الإنسان" إلا الإسم والشكل الخارجيّ. يُمكننا تشبيههما بسفينة غارقة في قعر البحر، أو بشيء قد ضربه "الصدأ"... هما شخصان إستُعبدا بالكامل ولم تعد لهما إرادة حرّة واعية. هما شخصان يهرب منهما الجميع، يخاف منهما الجميع، ويحكم عليهما الجميع. وإستطراداً، نقول إن مرقس ولوقا قد حرصا على إيراد إسم "الروح النجس"، وهو "لجئون" أي جوقة، فإن عرفنا أن "لجئون" تعني مجموعة من قرابة ستة آلاف شخص، لأدركنا مدى إستعباد هكذا أشخاص من "الشياطين"، ومدى هبوطهم إلى الحضيض.
هما إذاً صورة عن العبوديّة الشخصيّة بالكامل لعالم الخطيئة والشرّ، وتسليم الذات إلى "الشياطين" (الأهواء الشرّيرة على إختلافها) وليس إلى الله، وإلا لماذا كانا يسكنان القبور؟ حين نُصبح عبيداً لخطيئتنا، نبتعد عن النعمة الإلهيّة، ونسكن بدورنا "القبور"، حيث لا حياة بل موت فعليّ... بالخطيئة، تسكن نفوسنا في "القبور" قبل أن تسكنها أجسادنا. حين ننغمس بالرذيلة، نبتعد عن "النور" وعن عيون الناس، لأننا نخجل بأفعالنا، ونكون "فضّلنا الظلمة على النور"... كما أنه، في الرؤية الشاملة، هذان "المجنونان" هما صورةً عن حال البشريّة جمعاء التي إستعبدها "إبليس" وأبعدها عن سبل الله، ولم تعد قادرة على التحرّر بمجهودها، "فأعوزها مجد الله" (رو 3: 23)... وعلى مثال الممسوسَين العائشَين في العراء وخارج مدينتهما، فإن البشريّة أصبحت عارية من نعمة الله وبالتالي خارج الفردوس (خارج قلب الله).
* في النقطة الثالثة، وفيما نرى يسوع يأخذ المُبادرة ويشفي المجنونَين (ذلك أنهما فاقدا الإدراك الفعليّ من كثرة "الشياطين" التي إعترتهما)، نرى هذه "الشياطين" يُصيبها الهلع بمجرّد رؤيتها ليسوع، وتُسارع إلى الإعتراف بألوهيته وسيادته المُطلقة... من هذه الناحية، عرفت "الشياطين" من هو يسوع، ولم يعرفه الكثيرون من شعبه الذين شاهدوا آياته وسمعوا كرازته (كعلماء الشريعة مثلاً)... وهلع "الشياطين" ناتج عن معرفتها بالمصير المُخصّص "لإبليس وملائكته" وبالزوال النهائيّ لمملكة الشرّ وحلول "ملكوت الله"، ولإعتقادها بأن يسوع جاء يقضي عليها "قبل الأوان" (أي قبل "اليوم الأخير"، يوم الدينونة العامة). من هنا، طلب "الشياطين" إلى يسوع عدم القضاء عليها الآن، كما أنها لم تطلب دخولها إنساناً آخر، لمعرفتها بأن الربّ يسوع جاء مُحرّراً البشر من قبضتها، بل طلبت دخولها في الخنازير. وبما أن الخنازير تُعتبَر حيوانات نجسة في البيئة اليهوديّة، فهي بذلك تليق "بالشياطين". وحين دخولها في الخنازير، لم تحتمل حتى هذه الحيوانات تأثير "الشياطين" عليها، فرَمَت بنفسها في البحيرة، أي أن "الشياطين" جرّت عليها الموت. وهذه إشارة إلى الحالة المزرية التي قد يصل إليها كل من يُصبح عبداً للخطيئة ويبتعد عن الحياة الحقيقيّة بالله.
* في النقطة الرابعة، ما يلفتنا هو موقف سكان تلك المنطقة بعدما أخبرهم رعاة الخنازير بما جرى، فجاؤوا إلى المكان وعاينوا ما حصل... فلم يهتمّوا قطّ بشفاء الرجلَين، أو بظهور علامة من علامات "ملكوت السماوات". لم يفرحوا بشفاء إبنَي مدينتهم، وبعودة كرامتهما الإنسانيّة إليهما، بل خافوا فوراً على مصادر رزقهم، وطلبوا إلى يسوع المغادرة... لم تُحرّك فيهم هذه الآية ولو إحساساً بالحشريّة مثلاً، لمعرفة من هذا الذي له سلطان على طرد "الشياطين". وهذه حال كل واحد منّا حين يُفضّل مصالحه وأمجاد العالم على الدخول في سرّ الحياة بالله، ولا يفرح لشفاء أخيه من خطاياه (موقف الأخ الأكبر في مثل "الإبن الضال"). فعلينا أن ندرك أن إبن الله دخل في صميم حياة البشر "لكي يُخلّص ما قد هلك" ويُعيد الخليقة إلى حياة النعمة... شتّان (فرق شاسع) ما بين موقف هؤلاء "الجدريّين" الذين رفضوا يسوع، وموقف السامريّين الذين إستضافوه مدّة يومَين في ما بينهم، وقبلوا كلمة الحياة.
------------------------------------------------
ثالثاً – الخُلاصة الروحيّة:
وبعد، إن هذه الرواية تبيّن لنا حالة الإنسان (وكذلك العالم) المُبتعد عن الله والمُستعبَد من "إبليس"، والذي "يُعوِزه مجد الله". إن الإنسان الذي ينقاد إلى نزواته الأرضيّة، الزائلة، المؤقتة إلخ... ويُصبح عبداً لها، يكون على مثال "مجنونَي الجدريّين"، ويعيش في "قبر" أو سجن أهوائه. وكلّنا يعلم في قرارة نفسه ما أكثر "الشياطين" في حياتنا، وكم أن النفس البشريّة هي "ساحة صراع" يوميّ بين الرغبة في الخير وعمل الشرّ، كقول بولس الرسول "الخير الذي أريده لا أفعله، والشرّ الذي لا أريده إياه أفعل" (روم 7: 19)... إن مجد الله ظهر في شخص يسوع المسيح إبن الله المتجسّد، الذي جاء ليصنع مشيئة أبيه السماويّ ("لا تكن مشيئتي بل مشيئتكَ")، وهي خلاص ما قد هلك وإعادة الخليقة إلى حالة النعمة الأصليّة. وكل بشارة الإنجيل هي لإخبارنا عن محبّة الله التي ظهرت في ملء الزمان، عبر الخلاص الذي تمّ بيسوع المسيح، والذي جوهره تحرير الإنسان من عبوديّة الخطيئة والموت.
لقد أظهر الربّ يسوع بهذه الآية سلطانه الإلهيّ المُطلق حتى على "الأرواح النجسة"، وبيّن لهذه "الشياطين" أن نهايتها لا بدّ آتية، لأن ملكوت الله قد إقترب بشخصه، مُحرّراً البشر من نيرها. وسوف يبقى هذا "التجاذب" بين مملكة الشيطان وملكوت الله قائماً، بدءاً من تجربة يسوع في البريّة، مروراً بطرد الشياطين من البشر، وصولاً إلى "عرس" الصليب، حيث إعتقد الشيطان أنه إنتصر على إبن الله. لكن الإنتصار النهائيّ سيبدأ في "اليوم الذي صنعه الربّ"، وسوف يكتمل في "اليوم الأخير" حيث ستكون لله الكلمة الأخيرة.
بقلم الاخ توفيق ناصر (خريستوفيلوس)