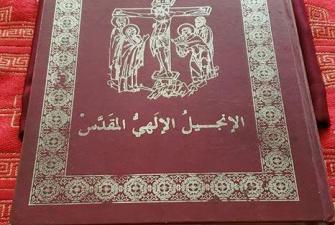أنت هنا
تذكار القدّيس الشهيد ميناس المصري (+296م)
11 / 11
ولد القدّيس ميناس المصري في أواسط القرن الثالث للميلاد، استشهد في أيام الامبراطور مكسيميانوس (296ــ 304م). شغف بالعسكرية منذ حدائته، فلما اشتد عوده انخرط فيها. وقد كان قوي البنية، مغواراً، رجل انضباط. عرف المسيح فبات، الى ذلك، حكيماً زاهداً.
وقي ذلك الزمان جمع القائد الروماني فرميليانوس فرقاً شتى من العسكر تمهيداً لنقلها الى افريقيا الشمالية، وقد زوّدها بتوجيهات من ضمنها ان على الجنود ان يحذروا المسيحيين ويلقوا القبض على الذين لا ينصاعون منهم لأحكام قيصر. وكان ميناس نازلاً، يومذاك، فرقة فيرجيا، في آسيا الصغرى. فما أن طرقت اذنيه أوامر القيادة العسكرية العليا حتى أصيب بصدمة وشعر بالحنق والقرف فقام وخلع سيره وألقاه أرضاً وفرّ الى الجبال لأنه اعتبر مساكنة الضواري خيراً من مساكنة عبدة الأوثان وهؤلاء أكثر بهيمية من أولئك.
أقام ميناس في الجبال ردحاً من الزمان ناسكاً عابداً. وقد ساعدته تنشئته العسكرية على ضبط أمياله ومحاربة أهوائه الى أن بات قوياً في الروح، ثابتاً، راسخاً مستعداً للمهمات الصعبة. ساعتئذ جاءه إعلان إلهي انه قد حان أوان الرضى وآن أوان الاستشهاد. فقام ونزل الى المدينة، فيما كان الوثنيون يحتفلون. ثم دخل بينهم وهتف:" ألا اعلموا يا قوم انه ليس هناك غير اله واحد حقيقي: المسيح، والذين تعبدونهم ليسوا سوى قطع من الخشب الأصم لا حسّ فيها!". فكان لكلماته في نفوس الناس وقع الصاعقة. وحالما استعادوا رشدهم انقضّوا عليه وأشبعوه ضرباً ولكماً، ثم أسلموه الى حاكم المدينة، فانتهزها فرصة يسلي فيها الجموع بتعاذيب شاهد آخر للمسيح.
عمد الحاكم، بادىء ذي بدء، الى الاستعلام:" من هذا الوقح وما مكانته؟!" فأجاب ميناس بكل جرأة وقال:" أنا من مصر واسمي ميناس. كنت ضابطاً في الجيش. ولكن لما رأيت عبادتكم للأصنام رددت كراماتكم وجئت اليوم أعلن بينكم ان المسيح هو الإله الحي الحقيقي وحده...". فأمسك الحاكم نفسه بعضاً وحاول، بالتهديد والوعيد، ثم بالاستمالة والوعود، ان يزحزحه عن موقفه فأخفق. اذ ذاك أسلمه للمعذّبين فجلدوه بوحشية وفركوا جراحه بقطعة شعرية خشنة. ثم سلخوه وأحرقوا جنبيه بالمشاعل، وبعدما تفننوا في تعذيبه قطعوا هامته وأضرموا النار في بقاياه ليمحوا أثره. ولكن، تمكّن مؤمنون من استخراج بعض عظامه. وقد جرى نقلها، فيما بعد، الى الاسكندرية.
وفي التراث ان ظهورات القدّيس ميناس وعجائبه لا تعد ولا تحصى، وقد عرفه المؤمنون معيناً لهم في الشدائد والضيقات ومؤدباً للكفرة والمنافقين. والصورة التي اعتاد الناس رؤيته عليها هي صورة فارس على جواد.
تذكار أبينا البار ثاودوروس الستوديتي المعترف
(+826م)
11 / 11
نشأتة وزمانه
ولد القدّيس ثاودوروس في القسطنطينية في العام 759م، في حضن الارستقراطية. وقد امتاز زمانه بحرب كان وطيسها يخف حيناً ويشتد أحياناً على الايقونات ومكرميها والمدافعين عنها. يذكر أن هذه الحرب كانت قد أندلعت في العام 726. واستمرت، بصورة متقطعة، الى العام 842 للميلاد حين تمّ وضع حد نهائي لها. كانت ولادة ثاودوروس في زمن الامبراطور قسطنطين الخامس كوبرونيموس لأب يدعى فوتين كان حافظاً للخزانة الملكية ووزيراً للمالية ولأم تدعى ثيوكتيستي كانت تقية متمسكة بالايمان الأرثوذكسي وحياة الفضيلة. ويبدو ان حميّة ثاودوروس النسكية وحبّه للصلاة كانتا من فضل أمه بعد ربّه عليه.
خاله والرهبنة
تلقى ثاودوروس نصيباً ممتازاً من العلوم الدينية والدنيوية المعروفة في زمانه. كان لخاله القدّيس أفلاطون الذي تحتفل الكنيسة بذكراه في الرابع من شهر نيسان، الدور الأبرز في بلورة أمياله الرهبانية والتزامه الحياة الملائكية. والحق ان تأثير القدّيس افلاطون تخطى ثاودوروس ليشمل كافة افراد الأسرة: الأب والأم والأخوة والأخوات وحتى بعض الأصدقاء الذين اقتبلوا الحياة الرهبانية بصورة جماعية. وقام فوتين، الأب، الى ارزاقه فباعها الا عقاراً في جبل الأوليمبوس في بيثينيا ووزّع أثمانها على الفقراء. يذكر ان جبل الاوليمبوس كان موثل الرهبان الاول في آسيا الصغرى، لا بل في الامبراطورية كلها، قبل ازدهار الجبل المقدّس المسمى آثوس. وكان هذا العقار يتضمن بعض الأبنية التي يمكن تحويلها الى أجنحة لدير مشترك. وهذا ما حدث بالفعل بحكمة القديس أفلاطون ومشورته. وكان اسم المكان ساكوذيون.
أقبل ثاودوروس على الحياة الرهبانية بهمّة ونشاط فسلك في الطاعة وقطع المشيئة وكشف الفكر. ورغم صحته الرقيقة وعلمه الغزير، كان يشترك في الأشغال البيتية واليدوية كأي راهب آخر: ينقل الماء والحطب ويفلح الأرض وينهض في الليل، سراً، لينقل الزبل على كتفيه. وقد صعد بسرعة سلم التواضع لأنه سلك في امّحاء ولم يعتبر كرامته أو حتى نفسه عزيزة لديه. كان ممتداً صوب ربّه وصوب اخوته. واذ قرن ذكر الله بذكر الموت منّ عليه ربّه في وقت قصير بموهبة الدموع. ويبدو أن دموعه كانت من الغزارة بحيث انه من تلك الساعة فصاعداً لم يمّر عليه يوم الا ذرف فيه الدمع مدراراً.
أوكل اليه خاله، القدّيس أفلاطون، بمهمة بناء كنيسة الدير فجاءت مثار اعجاب الجميع. الجدية في كل أمر كانت عنوان سعيه. كان يحب ان يخلد الى ربه وحيداً في الكنيسة لساعات طويلة أثناء الليل. وكان صارماً في نسكه وأصوامه دون مبالغات تضر بصحته وتوهن عزيمته على حفظ الصلاة.
راهباً حريصاً
سيم ثاودوروس كاهناً وهو في الثامنة والعشرين، فأضحى لذلك أكثر قسوة على نفسه مما كان، لا يرقد سوى ساعة واحدة في الليل ويقضي بقية وقته في الصلاة والتأمل في ما كتبه الآباء القدّيسون: القديس باسيليوس، القدّيس دوروثاوس الغزّاوي، القدّيس نيلس السينائي، القدّيس يوحنا السلمي وغيرهم وغيرهم. وقد كانت له مساهمة فعّالة في التنبية واصلاح ما اعوج من ممارسات رهبانية في جبل الأوليمبوس باتت مألوفة، كأن يحمل بعض الرهبان ما لهم من متاع الى الدير وان يكون لهم خدّام وان يهتموا بإقامة المزارع وتربية الدواجن. وان حرص القدّيس ثاودوروس ودقته وأمانته هو ما حدا بالقدّيس أفلاطون إلى أن يعرض على ابن أخته رئاسة الدير مكانه بعدما زاد عدد رهبانه وصار مئة. فأبى ثاودوروس تواضعاً، الى ان اضطر أخيراً للرضوخ للأمر الواقع بعدما أصيب خاله بمرض.
رجل المواجهة
وكما كان ثاودوروس رجل المواجهة في شؤون الحياة الرهبانية، كان كذلك في شؤون الكنيسة عموماً، لا سيما في حفظها من تسلّط الأباطرة والموظفين المتنفذين والوقوف في وجه ممارساتهم الكيفية واستهانتهم بالحق الكنسي. من ذلك وقوفه في وجه الامبراطور قسطنطين السادس بعدما طلّق زوجته لسبب أهوائي وأراد الاقتران بأخرى. وقد أبى البطريرك مباركة زواجه، فأتى الامبراطور بكاهن تمّم الزواج. وتحوّل التحدي إلى صراع طالما عانت منه الكنيسة في علاقتها بالدولة: سعي الدولة إلى فرض نفوذها على الكنيسة وسعي الكنيسة الى الحفاظ على استقلالية قرارها. وقد كان لثاودوروس دوره في هذا السياق لا سيما وانه كانت للرهبان، عموماً، كلمة يقولونها في القضايا التي تمس الكنيسة، عقائد وقوانين. وكانت النتيجة ان احتدمت المواجهة وعمد الامبراطور الى نفي ثاودوروس إلى تسالونيكي حيث مكث في ضيقات وشدائد سنة كاملة الى ان تمّت ازاحة الملك قسطنطين عن كرسيّة فعاد ثاودوروس الى ديره مظفراً واعتبره الشعب المؤمن رمزاً لصمود الكنيسة في وجه عبثية الحكّام في ديره كثيراً اذ اضطر في العام 798 للميلاد الى مغادرته الى القسطنطينية بعدما تواترت غزوات العرب لناحية جبل الأوليمبوس. هكذا انتقل أهل دير ساكوذيون برمتهم الى دير المعروف باسم " ستوديون" في القسطنطينية، نسبة الى القنصل الروماني" ستوديوس" الذي أسّسه في العام 463 للميلاد.
في دير الستوديون
في القسطنطينية، بدأت مرحلة جديدة من حياة القدّيس ثاودوروس استبانت أكثر خصباً ونضوجاً من التي سبقتها حتى اقترن اسمه باسم دير " ستوديون"، لأنه منذ أن وطئت قدماه الدير الجديد باشر فيه حملة مركّزة لإزكاء الحياة الكنسيّة مما جعله ولأجيال، أنموذجاً للعديد من الأديرة، لا سيما لدير اللافرا الكبير الذي أسّسه القدّيس أثناسيوس الآثوسي في القرن العاشر، وللأديرة الروسية ابتداء من القرن الحادي عشر. يذكر ان عدد رهبان دير " الستوديون" ما لبث ان تعدّى الألف. وقد اهتم ثاودوروس بجعل الحياة المشتركة فيه على النمط الباسيلي أكثر من دير ساكوذيون. ففي" ستوديون" كانت حياة الرهبان صورة أمنية عن الحياة في الكنيسة الرسولية: قلب واحد ونفس واحدة وكل شيء مشترك ( أعمال الرسا4: 32). لم يكن للرهبان قلالي خاصة بل عنابر واسعة يشتركون فيها ولا يلبسون الا ثوباً واحداً يتبادلونه من وقت الى آخر. كانت شؤون الدير تنتظم كل يوم بلياقة وترتيب وكان ثاودوروس قد اعتمد كموسى قديماً ( خروج18) نظاماً وزّع فيه المهام الروحية والمادية وفقاً لتراتبية معينة بحيث أمكنه أن يشرف على سير شؤون الدير وأن يبقى أباً لكل واحد من رهبانه.
اعتاد ثاودوروس، أثناء الخدم الالهية، ان يقتبل اعترافات الرهبان وكشفهم لأفكارهم. وكان يعظ ثلاث مرّات في الاسبوع خلال خدمة السحر. وقد وضع أعداداً من الأناشيد الكنسية. والمعروف ان كتاب" الترديودي" لدينا يعود اليه.
كان الدير أشبه بخلية نحل نشطة يعمل فيها كل راهب وفقاً لطاقته وموهبته: فهناك رسّامو الايقونات والنسّاخ والمزخرفون وهناك الصنّاع والحرفيون. كل ذلك وغيره جعل الدير المركز الايماني والثقافي الآول في زمانه.
منفياً من جديد
وان هي الا سنوات معدودات حتى تعرّض ثاودوروس للنفي من جديد. هذه المرة لأنه قطع الشركة مع البطريرك نيقيفوروس بعدما أعاد هذا الأخير الاعتبار للكاهن يوسف الذي تجرأ فبارك الزواج غير الشرعي للامبراطور قسطنطين السادس كما سبق فذكرنا. كان ذلك في العام 809 للميلاد وقد اهتم ثاودوروس من منفاه بتوجيه العديد من الرسائل الى تلاميذه والمؤمنين.
استمرت فترة نفيه هذه سنتين عاد بعدها الى ديره لينعم بسنوات قليلة من السلام. ثم في العام 815 للميلاد بدأ مواجهة جديدة شرسة ضد الامبراطور لاون الأرمني الذي باشر، من جديد، حملة لاضطهاد مكرمي الايقونات والقضاء عليها. وقد كانت لثاودوروس في الدفاع عن الايقونات عظات ومقالات كثيرة. وقد عمد، في موقف تحد، في أحد الشعانين من العام 815 للميلاد، الى تنظيم مسيرة في الشوارع اشترك فيها ألف راهب حملوا الايقونات ورتلوا الأناشيد اكراماً لها. وكانت النتيجة ان تمّ سجنه ونفيه من جديد. ورغم انه كان ممنوعاً عليه ان يراسل أحداً فإنه تمكن من كتابة عدد كبير من الرسائل وجهها الى رهبانه والى المؤمنين هنا وهناك. اذ ذاك جرى نقله الى برج في أقاصي الأناضول للحؤول دون اتصاله بالعالم الخارجي. وقد عانى من الرطوبة والبرد ومنع عنه الطعام الا خبزة كل يومين. ومع ذلك لم يفقد شيئاً من شدة عزمه واصراره على المراسلة. لسان حاله كان ولو انقطع عني ورق الكتابة لاتخذت جلدي ورقا ولو جفّ المداد لاستعنت بدمي. ويبدو ان تلاميذه كانوا من الحيوية والنشاط بحيث وفّروا له ما يحتاج من ورق وحبر فكتب المئات من الرسائل، حتى بلغت أورشليم وروما والاسكندرية.
نهايته
الى ذلك تعرّض ثاودوروس للجلد مرّات وترك يسبح في دمه، لكن الله كان معه. واستمرت حاله على هذا المنوال حتى العام 820 للميلاد. ولكن، حتى بعد ذلك لم يعرف الهدوء تماماً اذ ان الملك ميخائيل الثاني الألثغ ( 820ــ 829) أخرج المساجين من سجونهم وأعاد المنفيين من منافيهم، ولكنه لم يعد الاعتبار للإيقونات. لذلك هاجم ثاودوروس الملك بعنف لموقفه في العام 824 للميلاد فأخرجه الملك من العاصمة فتنقل بين عدة أديرة الى ان وافته المنية في 11 تشرين الثاني من العام 826. يومها كان قد تحّول من كثرة الأتعاب والمشاق الى شبه هيكل عظمي وكان مرض خطير قد أصاب معدته. وقد سأل تلاميذه ان يأتوه بالقدسات. وبعدما تناولها قال لهم ان يبدأوا بخدمة الجناز. وفيما كانوا يتلون المزمور 118 وقد بلغوا الآية 93 التي فيها:" لن أنسى فروضك أبدأ لأبك بها أحييتني" أغمض عينيه وأسلم الروح. عمره يومذاك كان قد بلغ السابعة والستين.
تذكار القدّيسين الشهيدين فيكتور واستفانس( القرن الثاني للميلاد)
11 /11
كان فيكتور عسكرياً من أصل ايطالي في ثكنة من ثكنات في زمن الامبراطور انطونينوس (138ـ161م). وشى به بعض رفقائه انه مسيحي فألقى الحاكم العسكري، سباستيان، القبض عليه وأخضعه للاستجواب، فاعترف بالمسيح ولم ينكر. ولما أبدى ثياباً ولم يهن أحاله الحاكم على التعذيب، فحطم الجلاّدون اصابع يديه وألقوه في أتون متقد بقي فيه ثلاثة أيام دون أن تمسّه النار بأذى. ولما خرج من الأتون سقوه سماً مميتاً أعده أحد السحرة. واذ تبينّ ان السم لم يفعل في جوف فيكتور اختشى الساحر وأعلن أن اله فيكتور هو الإله الحي الحقيقي وحده.
بعد ذلك عمد المعذبّون الى وسائل تعذيب اضافية فنزعوا بعض أعصابه وألقوه في قدر من الزيت المغلي، ثم في كلس وخل. وأخيراً، قلعوا عينيه وعلّقوه ثلاثة أيام مقلوباً الى ان لفظ أنفاسه وأسلم الروح.
وحدث ان أرملة تقية حضرت جهادات الشهيد وعاينت، في الروح، اكليلين بهيين يرتفعان الى السماء فتحركت نفسها وتقدّمت من الحاكم واعترفت هي أيضاً بالمسيح. فأخذها الجند وقيدوها الى نخلتين شدتا احداهما الى الاخرى بالحبال، ثم فكوا الحبال وتركوا النخلتين تذهب كل في اتجاه ففسختا استفانس الى اثنين، فأحصيت مع القدّيس فيكتور.