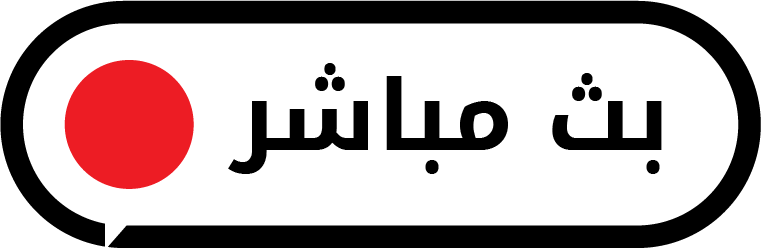أنت هنا
بدء الانذقتي
1/9 غربي (14/9 شرقي )
يعرف بدء السنة الجديد، في كنيستنا ، بــ "الانذقتي" من اللفظة اليونانية "انذقتيون". اللفظة، في الأساس، تعني حداً من الزمن يصدر فيه أمر عن الارادة الامبراطورية يوجب على الرعية تسديد ضريبة خاصة بتغطية النفقات العسكرية. كان ذلك يتم قبل الشتاء، بوقت قصير، من كل سنة. ويبدو انه كان هناك أكثر من تاريخ للانذيقتي في الشرق والغرب، ففيما شاع في الغرب الاول من شهر كانون الثاني، تعيّن، في الشرق، في الاول من شهر أيلول.
إلى هذا، اعتادت المسكونة-أي العالم القديم-اعتبار شهر أيلول موسم جمع الثمار والحبوب الى المخازن، وإعداد العدّة لالقاء البذور، في الأرض، من جديد. من هنا احتفال الكنيسة ببدء السنة الزراعية ورفع الشكر والطلبة الى الله.
من جهة أخرى، تحتفل الكنيسة، في هذا اليوم، بذكرى دخول الرب يسوع المسيح الى مجمع اليهود في الناصرة، حيث دفع اليه سفر إشعياء النبي.
إذ تحتفل الكنيسة بهذه الذكرى، تدخلنا في الزمن الجديد، في سنة الرب المقبولة، في زمن ملكوت السموات الذي دشّنه الرب يسوع المسيح عندما أعلن، بعدما انتهى من قراءته من سفر إشعياء، "انه اليوم قد تمّ هذا المكتوب في مسامعكم"
على هذا يكون بدء الانذيقتي "بدء السنة الكنسية الجديدة" قد اقترن، عبر التاريخ، بتدبير اداري ملكي، وتطعّم بمسعى لتقديس الخليقة والمواسم، وتتوّج بالدخول في "سنة الرب المقبولة".
وقد حدد الآباء القديسون أن يقام الاحتفاء بالسنة الطقسية أو كما تسمى الانذقتي في الأول من شهر ايلول
تذكار أبينا البار سمعان العمودي ( الكبير)
إن البار سمعان العمودي الذي تعيّد له الكنيسة اليوم هو غير سمعان العمودي البار الذي من الجبل العجيب. الاول رقد، في الرب، حوالي العام 461، أو ربما 459 للميلاد، والأخير حوالي العام 596 للميلاد. لكن الاثنين نسكا في منطقة جغرافية واحدة، فسلك الثاني في خطى الأول. ومع مرور الزمن، ارتبط ذكر الواحد، في ذهن المؤمنين، بذكر الآخر، حتى ان الايقونة تصوّرهما، في العادة، معا. والى جانب هذين البارين هناك ثالث اسمه سمعان نسك على عامود. هذا الأخير لا نعرف متى رقد في الرب، لكن السنكسار اليوناني يجعل عيده في 27 نيسان، فيما عيد سمعان العجيب هو في 24 أيار. وللتمييز بين الثلاثة يعرّف عن الاول بــ "الكبير"، وعن الثاني بــ "العجيب" أو "العجائبي"، وعن الثالث بــ "الأصغر".
لا شك إن سيرة القدّيس البار سمعان العمودي الكبير هي سيرة فريدة فلقد أثارت، عبر التاريخ، وما تزال، أسئلة وتساؤلات عديدة واستغرابا يذهبن أحيانا، الى حد الاستهجان، وربما التشكيك باستقامة نسكه. ذلك انواع النسك التي مارسها، والطرق التي اعتمدها في صلاته الدائمة النقيّة الى ربّه، ليست، في بعض جوانبها، من الانواع والطرق المألوفة في الحياة الرهبانية في الكنيسة، لا بل هي مما جرى الآباء ويجرون على صرف طالبي الرهبنة عنه، نظرا لمخاطر التي تحاذي، احيانا، حدود الانحراف. من ذلك، مثلا، قمع الجسد الى درجة التعذيب، وترك جراح البدن تتقيّح الى درجة التدوّد، والاستغراق في الصوم حتى التلاشي، والاقامة على عمود في العراء صيف شتاء.
إن مثل هذه القسوة غير ممدوحة ولا محبّذة ولا شائعة في تراث الكنيسة. هي حالات خاصة لا يقاس عليها. ولكن، إذا كانت هذه حالات خاصة، فليس معنى ذلك أنه يحقّ لنا أن نندّد بها ونشك باستقامة سيرة أصحابها الروحية. حسبنا، والحال هذه، أن ننظر اليها من خلال سيرة أصحابها الاجمالية، لا في ذاتها. لا قيمة، أبداً، لهذه الطرق في ذاتها. ليس النسك غاية، بل الغاية هي أن يصبح الرب يسوع الكل في الكل في حياة الناسك. كذلك، ليست كل طرق النسّاك واحدة، وان كان هناك ميل الى إتباع طرق السابقين، في بعض جوانبها، لأنها مختبرة. المزاج، العقلية، الثقافة، الخلفية الاجتماعية، والخلفية العائلية الخ... كل هذه تحدّد طبيعة العلاقة الشخصية بالرب يسوع المسيح، له المجد، وبالتالي أنواع النسك التي يسلك الناسك فيها.
بالنسبة لسيرة القديس البار سمعان العمودي الكبير بالذات، لا يمكننا كما سيظهر لنا، بعد قليل، الا أن نعترف بالنعم الهائلة والمواهب الخارقة التي منّ بها الرب يسوع على حبيبه سمعان، وعلى الكنيسة من خلاله. القدّيسون الكبار نحن لا ننتقدهم، ولا نطبّق عليهم قواعد ضيّقة، بل نتلقّفهم، نتلقّف الروح الساكن فيهم، كما تتلقّف الأرض العطشى زخّ المطر. واما غرائب سيرهم فحسبنا، أمامها، أن نهتف: "عجيب الله في قدّيسيه"، "لقد جعل الله قدّيسيه في الأرض عجباً"!
ولد القدّيس سمعان حوالي العام 392 للميلاد في قرية اسمها صيص، بين سوريا وكيليكيا. نشأ في بيت فقير تقي وكان له بعض الاخوة. اسم والده كان ايزيخيوس (هادي) وأمه مرتا. مهنة أبيه كانت رعاية الأغنام. وعلى رعاية الأغنام كبر سمعان ايضا.
اعتاد أبوه إرساله وحيدا الى الجبال، في الجوار، ليرعى الغنام فيها. ولعلّ هذا هو ربىّ فيه روح التوحّد والسكون، وعادة الجلوس الى الطبيعة العارية الصافية متأملا، ومناجاة رب الطبيعة.
ذات يوم، أثلجت الدنيا فلم يخرج سمعان بالقطيع الى المرعى، كعادته. وخطر بباله، عوض ذلك، ان يذهب الى الكنيسة، رغم رداءة الطقس هناك في الكنيسة، كان الشمّاس يتلو التطوبيات من الانجيل:"طوبي للباكين وويل للضاحكين... طوبى لأنقياء القلوب..."، فحركت هذه الكلمات قلبه، وأحسّ بأنه هو المعني بها، فسأل ماذا عليه ان يفعل لينال الطوبى، فحدّثوه عن الحياة الرهبانية وقالوا له انها هي الحياة الملائكية الكاملة التي تبلّغ الى فرح الرب. فأسرة الكلام عن هذه الحياة، وراح يصلي طويلة الى أن غفا. وفي غفوته عاين الرؤيا التالية: بدا له كأنه كان يحفر أساسات لبناء ما، واذا بصوت يقول له: "هذا ليس كافيا... عمّق الحفرة اكثر..."، فاستمر. وعاد اليه الصوت اربع مرّات بنفس الكلمات الى ان قال له اخيرا: كفاك الآن! هيا باشر بالبناء وسيكون الأمر سهلا، ولكن عليك أولا أن تقمع نفسك بعناد، إذ ذاك ترتفع بيسر إلى أعلى الكمالات. فلما استفاق شعر بنفسه جريئاً، ممتلئاً قوة سماوية، فقام، لتّوه والتصق بأقرب دير. وقد كان على الدير أب قدّيس اسمه تيموثاوس. سنّه، يومذاك، لم تكن قد بلغت الخامسة عشرة.
هناك، في ذلك الدير، فتح سمعان عينيه على أصول الحياة الروحية. ويبدو أنه فاق سواه من الرهبان في الطاعة والتقشّف. ولكن إقامته فيه لم تدم أكثر من سنتين لأن ميله كان شديداً إلى حياة أكثر تقشّفاً من تلك التي كانت سائدة هناك.
انطلق سمعان إلى دير كان معروفاً باسم المنظرة (أي الدير). هناك كان ثمانون راهباً يجاهدون في سبل الحياة الرهبانية برعاية راهب تقّي حكيم صارم اسمه هليوذورس. قضى سمعان في هذا الدير عشر سنوات، كان خلالها مثال الراهب المطيع، المتضع، الخدوم، الباش. أمر واحد فرّقه عن غيره: قسوته المفرطة على نفسه. ففيما اعتاد الآخرون تناول الطعام مرة كل يومين، كان هو لا يتناول سوى وجبة يتيمة واحدة في الاسبوع. كذلك، صنع حبلاً خشناً من جريدة النخل وشدّه على وسطه، تحت ثيابه، حتى اخترق لحمه عميقاً. لم يدر بأمره أحد في البداية. ولكن، لما اكتشف رؤساؤه ما صنع أنبوه وأمروه بنزع الحزام فأطاع، إلا أن الحبل كان قد اخذ من لحم سمعان وأثّر في صحته، مما اضطره إلى ملازمة الفراش شهرين كاملين قبل ان يستعيد عافيته.
وخشي رئيس الدير على رهبانه من سمعان فصرفه.
انطلق سمعان، دونما تذمّر أو قلقن صوب البريّة. وبعدما قطع مسافة طويلة، وصل إلى بئر نضب ماؤها، فأقام فيها عشر يوماً يسبّح الله ليل نهار كمن لا جسد له، ولا صلة له بالدنيا. في هذه الاثناء حرّك الرب قلوب الرهبان في الدير فاختشوا، فخرجوا يطلبونه. ولم يهتدوا إلى مكانه إلا بعد عناء، فعاد سمعان معهم إلى الدير، طاعة، إلا أن إقامته بينهم كانت قصيرة، بعد ذلك لنه عاد الى قسوته السابقة على نفسه، فعادوا وصرفوه من جديد.
وكانت المحطة التالية في مسيرة قديسنا ناحية اسمها تيلانيسون غير بعيدة عن مدينة انطاكية. هناك وجد سمعان كوخا مهجورة فنسك فيها ثلاث سنوات. وكان يفتقده كاهن اسمه بلاسوس اعتاد ريادة المكان.
ورغب سمعان، اقتداء بالرب يسوع المسيح ونبيّيه، موسى وايليا، ان يقضي الصوم الاربعيني دون ان يأكل شيئا. فطلب من صديقه الكاهن ان يسدّ عليه باب الكوخ بالحجارة، فكان له ما أراد، بعد أن زوّده الأب بلاسوس بقليل من الخبز والماء، حتى إذا ما وهن جسده يكون له ما يتقوّى به قليلا.
ومرّت أيام الصوم الاربعون، فجاء الكاهن بالقدسات ورفع الحجارة عن مدخل الكوخ، ثم دخل الى داخل، فوجد الخبز والماء على حالهما، وسمعان مطروحا بلا حراك، ضعيفاً لا يقوى على التفوّه بكلمة واحدة. ولم يستردّ سمعان قواه إلا بعدما ناوله الكاهن القدسات.
ومن تيلانيسون، انتقل سمعان الى قمة جبل بنى عليها لنفسه قلاّية بسيطة جعلها مكشوفة، بلا سقف، وانصرف الى أصوامه وصلواته غير عابىء بتقلّبات الطقس. ولكي يرّد سمعان عن نفسه تجربة مغادرة المكان، استعان بحدّاد ربط له رجله اليمنى بسلسلة حديدية طولها عشرون ذراعا قام بتثبيتها الى صخرة.
ومرّ بقدّيسنا خور اسقف حكيم اسمه ملاتيوس. فلما رآه على هذه الحال قال له: " ان القيود الحديدية هي للحيوانات المفترسة، اما الانسان فتكفيه ارادته رباطا بمؤازرة النعمة الالهية". وشعر سمعان في نفسه بأن هذه رسالة من الله فأطاع.
وجيء بحدّاد ليكسر القيد، ثم قام ملاتيوس بنزع قطعة من الجلد القاسي كانت موضوعة حول القدم لحمايتها من ثقل القيد وضغطه. وما ان فعل حتى بانت القدم على هيئة تقشعر لها الأبدان: كانت قد انتنت ودادت! كل الذين عاينوا المشهد اصيبوا بالذعر والدهش وطوّبوا الصبر العجيب الذي لهذا الانسان.
وتوافد الناس على سمعان في منسكه فخشي اكرام الناس له وان يضيّع ما تعب فيه كل هذه السنين، روح الصمت، روح الصلاة النقية، ففرّ الى مكان أبعد، في الجبال، واتخذ لنفسه قاعدة عمود صعد عليها مقيما مصلّيا. لكن الجموع اكتشف موطنه الجديد فتهافتت عليه، فأخذ يرفع العمود قليلا قليلا. وبارتفاع العمود ارتفع سمعان في مراقي النور الالهي، الى ان بلغ علو العمود ستة وثلاثين، الى اربعين ذراعا.
كانت للعمود قاعدة وساق وتاج. اما التاج فكان في هيئة جرن، قطره متر وعشون سنتيمترا، كان بإمكان سمعان ان ينام فيه القرفصى. والى جانب العمود، كان هناك حبل وسلّم للصعود والنزول.
على عمود أمضى سمعان اكثر من ثلاثين سنة عابدا، تحدّى خلالها برد الشتاء القارص وحر الصيف الحارق. وهج الشمس كان، احيانا، يذهب ببصره، تماما. اعتاد ان يقضي ليله كله وقسما كبيرا من نهاره في الصلاة. وان احدى ميزات سمعان مطّانياته (سجداته) الكبيرة. ذات مرّة، أخذ أحد الحجّاج يعد سجدات سمعان، فعدّ الفا ومئتين وأربعا وأربعين وتوقّف بعدما ملّ، فيما استمر القدّيس وكأنه آله تسبيح لا تتوقّف. كانت صلاته، كل يوم، تمتد من المساء الى ظهيرة اليوم التالي. وفي الأعياد الكبرى كان يرفع يديه وعينيه الى السماء ايضا. من جهة المأكل، يؤكد المؤرخ ثيودوريتوس ان سمعان لم يكن يتناول الطعام سوى مرة كل اربعين يوما، لكنه كان يقتبل القدسات مرة كل ثمانية أيام
لم يكن عند العاديين من الناس شك في قداسة الرجل، الا ان نظرة السلطة الكنسية له كانت مشوبة بالريبة، اول الأمر. ثم ما لبثت الحقيقة ان انجلت، وتبدّدت الشكوك بعدما اقتنع الأكثرون بأن مثل سمعان مثل انبياء العهد القديم كاشعياء وارميا وحزقيال، شاءهم الله ان يخرجوا الى الناس بغرائب السيرة ليصدم وجدانهم ويحرّك نفوسهم، بعدما قست قلوبهم وصمّت اذانهم عن سماع أقواله، وسرت فيهم تعاليم غريبة عن تعاليمه. سمعان كان رسالة المسيح الحيّة الى زمانه مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي.
إلى الآن، عرفنا عن القدّيس سمعان كثرة اصوامه وغريب نسكه وقسوته على نفسه وصبره على الآلام والضيقات صبرا عجيبا مذهلا، وكذلك الدائمة وطاعته. ما يجدر بنا معرفته ايضا هو انه كان تواضع ومحبّة وبساطة وبراءة وعذوبة قلّ نظيرها. قد يكون صحيحا ان اكثر من كانوا يتهافتون عليه من كل أرجاء المعمورة، من بلاد الفرس وأرمينيا وجيورجيا، ومن الحميريين والعرب وايضا من بلاد الغرب، من ايطاليا واسبانيا وبلاد الغال والجزر البريطانية، كان دافعهم الى زيارته ما سمعوه من غرائب سيرته ونسكه. بعضهم كان يأتي اليه بدافع الفضول والبعض تخشعا وتركا واستشفاء، والبعض استرشادا. بعضهم بنيّه صالحة وبعضهم بنيّة شريرة. ولكن الصحيح ايضا أن جلّ من التقوه، عادوا الى ديارهم بغير ما أتوا، لأن تواضعه وبساطته ولطفه وصلابته، أخذت بمجامع قلوبهم وتوّبت الكثيرين منهم وحملتهم على تعظيم الله في خلقه.
يحكى عن تواضعه وطاعته ان المتوحّدين في الجوار أدهشتهم طريقة سمعان الجديدة الغريبة فخشوا ان تكون من عمل الشيطان فاجتمعوا وأوفدوا من نقل باسمهم رغبتهم في ان ينزل سمعان عن العمود. وقد زوّدوا المرسلين بالتوجيه التالي: ان اطاع ونزل فاتركوه على عمود وتبركّوا به لأن الروح الفاعل فيه هو روح الرب، وان أبى وتصلّب علمنا أنه فريسة الغرور والكبرياء وليس عمله من الله. فلما بلغوه نادوه بكلام الآباء فنزل لتوّه وضرب لهم مطانية ووضع نفسه في تصرّفهم. فأيقنوا، اذ ذاك، انه من روح الرب، فتراموا على يديه يقبّلونهما ويسألونه البركة، ثم رجوه ان يعود الى عموده وأن يصلّي من أجلهم.
وكان من بين المتهافتين عليه الاصحّاء والمرضى، العظماء والعاديون، الفلاسفة والبسطاء، الكبار والصغار، المؤمنون والوثنيون وكانوا كالبحر عددا، على حد تعبير المؤرخ ثيودوريتوسّ. اما هو فكان يطل عليهم كل يوم مرتين يرشدهم ويعزّي قلوبهم، يعلّمهم ويستمع الى طلب كل واحد منهم، ثم يشفي مرضاهم ويحكم في خلافاتهم. وقد شرّفه الله بمواهب جمّة كالنبوّة ومعرفة مكنونان القلوب وشفاء المرضى والتعليم. كما ردّ الله الكثيرين، بواسطته، عن الشر والهرطقات وعبادة الأوثان. ولنا في محاضر المجمع المسكوني الثاني في افسس (431) رسالة وجّهها الامبراطور ثيودوسيوس الى سمعان يطلب منه فيها التدخل في الخلافات العقائدية والعمل من اجل السلام في الكنيسة.
أسلم القدّيس سمعان روحه على العمود، في اليوم الاول من شهر أيلول من العام 461، أو ربما من العام 459. وقد بقي ثلاثة أيام جائيا على ركبتيه قبل ان يكتشف أحد انه قد رقد. ظنّوه غارقا في صلاته، فلما صعدوا اليه ليسألوه عن سبب صمته وجدوه ميتا.
وقد صنع الله بواسطة رفاته عجائب كثيرة، فاقت، عددا، ما صنعه في حياته، كما ان رائحة الطيب بقيت تفوح من عموده مدة طويلة. ثم انه جرى نقل جثمانه الى انطاكية وأودع كنيسة القديس كاسيانوس ومن ثم كنيسة بنيت خصيصا له عرفت بكنيسة التوبة.
أما عمود سمعان فبقي محجّة على مدى العصور. وقد بنى الرهبان حوله ديرا وكاتدرائية ضخمة لها شكل صليب والعمود في وسطها. كان ذلك حوالي العام 490 للميلاد، وما تزال آثار الدير والكاتدرائية ماثلة للعيان على بعد ستين كيلومترا تقريبا الى الغرب من مدينة حلب في المنطقة المسمّاة بقلعة سمعان. وقد اعتاد المؤمنون ان يشاهدوا نجما عجيباً فوق المكان في يوم القديس كل عام. وتعود أخر شهادة في هذا الشأن الى مئة وثلاثين عاما بعد رقاده على ما روى احد المؤرّخين.