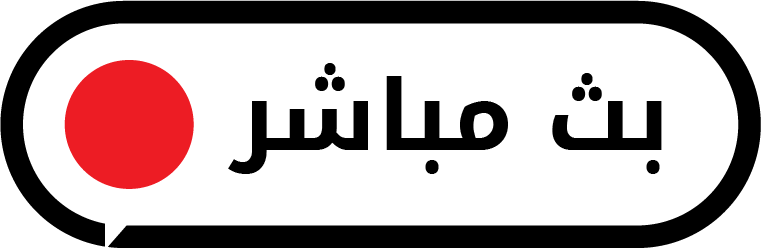أنت هنا
القدّيس البار ذيوس الأنطاكي (القرن 5 م)
19تموز غربي (1آب شرقي)
أصل القدّيس ذيوس من أنطاكية. هناك عاش طويلاً في النسك وأتعاب الفضيلة. ثمّ إثر رؤيا إلهية انتقل إلى القسطنطينة ليؤسّس ديراً . فلمّا بلغ الموضع الذي اختاره الله له، أخذ يستصلحه، ثمّ زرع في الأرض عصاه. للحال تجذّر العصا وصار شجرة كبيرة تثمر ثمراً جيّداً . جاءه الإمبراطور ثيودوسيوس الصغير (408 -425) زائراً فانتفع كثيراً من قضيلته وحكمته وخصّص له مبلغاً كبيراً من المال تمكّن القدّيس به من بناء دير فسيح.وقد احتلّ هذا الدير الثاني في الأهمية، في العاصمة المتملّكة، بعد دير القدّيس دلماتيوس. ثمّ إذ أصرّ القدّيس البطريرك أتيكوس (8 كانون الثاني) على سيامته كاهناً صار خادماً لنعمة الله، لا فقط لجهة الاحتفال بإقامة الأسرار الكنسيّة، بل في اجتراح عجائب جمّة أيضاً. على هذا استنبع، على غرار موسى، ماءء في أرض قاحلة سدّاً لحاجات الشركة، كما أقام ميتاً كان قد سقط في الماء شكّا.ً
لما بلغ ذيوس نجاز جهاداته، وكان طريح الفراش، بالكاد يتنفّس، والقوم متحلّقين حوله والدموع في عيونهم، بمَن فيهم البطريرك أتيكوس والبطريرك الأنطاكي ألكسندروس، في تلك الساعة بالذات انتصب المغبوط فجأة كمَن خرج لتوّه من نوم عميق وأعلن للحاضرين أنّ الله وهبه عشرة سنة إضافية.
بقي ذيوس يشيع الفرح وينفع الكثيرين إلى أن انقضت الفترة المعيّنة. إذ ذاك رقد بسلام. كان ذلك بين العامَين 425 و 430 م.
القدّيسة البارة مكرينا ورفيقاتها الأربع (القرن 5 م)
هي أخت القدّيس باسيليوس الكبير (1 كانون الثاني) والقدّيس غريغوريوس النيصصي (10 كانون الثاني)، وهي البكر في عائلة قوامها عشرة أولاد جلّهم قدّيسون. لمّا أبصْرت النور، سنة 327 م، تراءى شخص عجيب لأمّها في ثلاث مناسبات، وأمرها أن تسمّي الطفلة باسم القدّيسة تقلا، أولى الشهيدات ومثال العذارى، المعيّد في 24 أيلول. وقد حفظت الأم الاسم سرّاً فيما اتّخذت الابنة اسم جدّتها مكرينا الكبرى التي تتلمذت للقدّيس غريغوريوس العجائبي (17 تشرين الثاني) وعاشت في البنطس، في الغابات، زمن الاضطهاد الكبير.
اهتمّت أمّها بتنشئتها لا على الثقافة الدنيوية والطيش، كما كان حال مَن كانوا في مقامها، بل على ما كل ما كان، في الكتاب المقدّس، موافقاً لسنّها والأخلاق الحميدة، خصوصاً سفري الحكمة والأمثال. كانت مزامير داود ترافقها في كل أنشطتها: في نهوضها، في انكبابها على العمل، في استكمالها له، قبل المائدة وبعدها، قبل رقاد النوم وفي النهوض ليلاً للصلاة. لمّا بلغت الثانية عشرة من العمر استبان حسنها، خطبها شاب مميّز كان قد أنهى دراسته ووعد أن ينتظر مكرينا ريثما تبلغ سنّ الزواج. لكنّ الله أخذه إليه قبل العرس فتسنّى للقدّيسة أن تحقّق رغبتها العميقة في أن تحيا في العذرة التماساً لله. تقدّم لها العديدون، لكن آثرت مكرينا أن تعتبر نفسها أرملة، على هذا قطعت نفسها عن العالم وأقامت مع أمّها واهتمّت بحاجات المنزل، حتى ما كان مفترضاً أن بكون من نصيب العبيد لديهم. كذلك اهتمّت بمعاونة أمّها في تنشئة إخوتها وأخواتها. فلمّا رقد أبوها سنة 341م، تسّلمت إدارة الملكية العائلية الواسعة في البنطس وبلاد الكباّّدوك وأرمينيا. وهكذا، بمثالها الطّيب، دعت أمّها إلى التحوّل صوب الخيرات التي لا تفنى، أي التأمّل في الله والفلسفة الحقّ. بنتيجة ذلك سلكا معاً في الحياة النسكيّة وأقبلا على القراءة وتأمّل الكتب المقدّسة. وقد كانت مكرينا للجميع حامية ومربيّة ونموذج فضيلة في آن معاً. أمّا أميليا، والدتها، فلمّا استكملت تربية أولادها وزّعت عليهم ميراثها وحوّلت البيت العائلي في أنيسا (بقرب قيصرية الجديدة) ديراً. أمّا خادماتها فجعلتهن رفيقاتها في النسك، فيما نجحت مكرينا في إقناع باسيليوس العائد من أثينا، بعد دراسات لامعة، بالتخلّي عن مهنة واعدة، كأستاذ في البلاغة، ليقتبل الحياة الإنجيلية. هذا وقد نشأت بقرب دير النساء، الذي نما بانضمام أرامل نبيلات إلية، أخويّة للذكور بعهدة شقيق مكرينا الأصغر،بطرس، راعي سبسطية العتيد. كذلك عمد أخوها القدّيس نوكراتيوس (8 حزيران) إلى الاعتزال في مواقع شغله القدّيس باسيليوس، فيما بعد، على الضفّة المقابلة لنهر إيريس، وكان يهتمّ بتوفير حاجات الفقراء المسنّين من ثمار صيده.
فلمّا انعتقت مكرينا من ضرورات الجسد وضرورات الحياة سلكت ورفيقاتها في معتزلهن في سيرة على الحدود بين الطبيعة البشريّة الملائكيّة، لم يكن يرى لديهن لا غضب ولا حسد ولا حقد ولا تعظّم ولا شيء مثل ذلك. كل رغبة في الكرامة والمجد زالت لديهن. كانت لذّتهن في الإمساك ومجدهن في أن يكنّ، مجهولات من الناس وثروتهن في أن لا يقتنين شيئاً. كن يعتشن من تعب أيديهن، لكنهن أعتقن من كل همّ إذ تمثّل اهتمامهن في معاينة الحقائق الإلهية والصلاة المتواترة وإنشاد الأناشيد. لم يكن عندهن فرق بين الليل والنهار لأنّهن استبنّ، ليلاً، ناشطات في أعمال النور، فيما استكنّ في النهار من كل اضطراب. وقد تنقّى جسد القديّسة مكرينا بالنسك فكان كأنه جسد القيامة. كانت تذرف الدمع مدراراً وكل حواسها كانت خصيصة ما لله حتّى خفّت وسلكت في المعالي صحبة القوّات السماوية. وإن سيرة الفلسفة الحقّ، في المسيح بصّلب كل أهواء الجسد، أتاحت لها النمو المطّرد في الفضيلة حتى إلى ذروة الكمال الإنجيلي.
ذات يوم أصابها، في الصدر، ورم خبيث فلم تشأ، رغم توسّل أمهّا، أن تقتبل عناية الطبيب لها معتبرة أنّ كشف جزء من بدنها لعيني رجل أشدّ وطأة من ثقل المرض. في مقابل ذلك أمضت الليل في الصلاة، في الكنيسة، وادّهنت بالتراب بعدما أوحلته بدموعها. في الصباح سألت أماليا أن ترسم إشارة الصليب على صدرها فاختفى المرض ولمّا يترك غير ندبة طفيفة.
بلغت مكرينا حدّاً من اللاهوى جعلها إثر وفاة نوكراتيوس، أخيها، في حادث صيد، مثالاً في ضبط النفس والإيمان بالحياة الأبدية. كذلك استبانت على كبر في النفس بإزاء الوفيات التي تعاقبت على الشركة، فكانت غير متزعزعة، نظير مصارع معرّض للضربات. هذا ما استبانت عليه إثر وفاة أمّها، أميليا، وشقيقها، شمس الأرثوذكسية، القدّيس باسيليوس الكبير. وإذا ما ابتّليت بالحزن فعلى الكنيسة لخسرانها معلّماً وسنداً عظيماً، ثمّ خلال المجاعة التي ضربت بلاد الكبّادوك، سنة 368 م، أضحى دير أنّيسا مدينة حقّانية وملاذاً وعزاء لكل إنسان في الجوار. وبصلاة القدّيسة كان مخزون الحبوب الموزّعة على المحتاجين يتجدّد بصورة عجائبية.
بعد وفاة القدّيس باسيليوس بقليل، بلغ القدّيس غريغوريوس النيصصي أنّ أخته مريضة جداً فزارها بعد تسع سنوات من الغياب. كانت ممدّده على لوح خشب تكدّها الحمّى فيما روحها حرّة في تأمّل المراقي السماوية. وفيما كان الشقيقان يستعيدان ذكرى القدّيس باسيليوس الكبير، انتهزت مكرينا الفرصة، بدل أن تنتحب، فتناولت وإياّه مطوّلاً موضوع طبيعة الإنسان ومعنى الخلق والنفس وقيمة الأجساد. في كل من هذه الموضوعات كان كلامها ينساب كمياه النبع، يسيراً وبلا عائق. حتى اللحظة الأخيرة،لم يكفّ عن الخوض في الفلسفة الحقّ محبّة الختن غير المنظور الذي كانت تتعجّل الانضمام إليه دون أن يستبقيها أيّ تعلّق بهذه الحياة. فلمّا شعرت بدنو أجلها كفّت عن توجيه كلامها إلى مَن كانوا لديها وحوّلت عينيها إلى المشرق. وإذ بسطت يديها نحو الله تمتمت هذه الصلاة: :أيّها الربّ، أنت مَن بدّد عنّا الخوف
من الموت، أنت مَن جعل لأجلنا حّد الحياة هنا على الأرض مطلعاً للحياة الحقّانية. أنت مَن يعطي أجسادنا الراحة لبعض الوقت وتوقظنا من جديد على صوت البوق الأخير. أنت مَن ترك في الأرض ما جبلته يداه ليعود فيطلب ما أعطاه ، محوّلاً بالخلود والجمال ما هو فينا مائت ومشوّه. أنت مَن أعتقنا من اللعنة والخطيئة، صائراً لنا الأمريَن معاً أنت مَن حطّم رأس التنّين الذي أحدر الإنسان إلى جبّ العصيان، قابضاً عليه من الرقبة. أنت مَن فتح طريق القيامة بعدما حطّم أبواب الجحيم وأبطل قوّة مَن له سلطان الموت. أنت ممَن أعطى جميع الذين يخافونه علامة صليبه المقدّس ليُبيد العدو ويعطي الأمان لحياتنا. أيّها الإله الأزلي الذي إليه ألقيت من حشا أمّي، أنت مًن أحبّته نفسي من كل قوّتها أنت مَن كرّست له جسدي ونفسي منذ الشبابية وحتى هذه اللحظة، أنت اجعل لدي ملاك نور يقتادني من يدي إلى نوضع العزاء حيث ماء الراحة، في حضن الآباء القدّيسين. أنت مَن حطم شعلة السيف اللهيبي وأقام في الفردوس اللصّ الذي صُلب معه وأسلم لمراحمه،أنت اذكرني في ملكوتك لأنّي أنا، أيضاً، صُلبت معك، وسمّرت جسدي بمخافتك ، واستبدّ بي الخوف من أحكامك. لا تفصلني عن مختاريك بهوّة سحيقة. لا ينتصبنّ الحسود بإزائي على الطريق التي أسلك فيها ولا تُوضعن خطيئتي أمام عينيك إذا ما كنت لضعف طبيعتنا قد وقعت في الخطيئة بالفكر أو القول أو العمل. أنت مَن له على الأرض سلطان أن يغفر الخطايا، اغفرها لي لأتنفّس الصعداء، ومتى انفصلت عن هذا الجسد ظهرت أمامك بنفس لا تُدانى ولا عيب فيها كالبخور أمامك".
إثر هذه الكلمات رسمت القدّيسة علامة الصليب على عينيها وفمها وقلبها. ثمّ إذ اشتركت بصمت في خدمة المساء تنهّدت تنهّداً كبيراً وغادرت، في آن، صلاتها وحياتها على الأرض . خلال الصلاة عليها، التي ترأسها القدّيس غريغوريوس واشترك فيها جمهور كبير، تلألأ جمال القدّيسة مكرينا الروحي في جسدها الذي تزيّن كجسد فتاة مخطوبة. وإذ رافقتها التراتيل، كما في أعياد الشهداء ، ووريت الثرى في إيبورا، في الضريح الذي ضمّ رفات ذويها، في كنيسة الأربعين شهيداً.